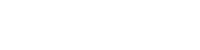العنف
تقديم
إن الرهان الأساسي من الممارسة السياسية هو السعي إلى السلطة وإقامة دولة الحق والقانون من أجل تدبير عقلاني وديمقراطي لشؤون المجتمع على أساس نظام تعاقدي إرادي يتنازل فيه الأفراد على ذاتيتهم وعن جزء من حريتهم الفردية والطبيعية من أجل التعايش في أمن وأمان، ومن ثم يمتثلون بنوع من التلقائية والرضى لسلطة الدولة التي لها حق السيادة من حيث أنها تمثل المجتمع بجميع شرائحه عبر أساليب الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة بحرية وشفافية، وعليه إذا كانت الدولة بالمعنى الحديث للمفهوم تتمثل في مجموع الأجهزة والمؤسسات التي تسهر على تدبير الشأن العام للمجتمع في مجالاته المختلفة سواء منها السياسية والاقتصادية والثقافية...، وبالتالي فهي مالكة السلطة، فإننا نتساءل:
- على أي أساس تقوم الدولة؟ هل على العنف والاستبداد أم على الحق والعدالة؟
- لماذا تلجأ الدولة أحيانا إلى استعمال العنف بكل أشكاله المادية والمعنوية؟ هل هناك من مبرر ومشروعية لهذا الاستعمال؟
- هل ممارسة العنف يقوي من سلطة الدولة أم يهدد وجودها واستمراريتها؟
- هل العنف ملازم ومحايث للسلطة أم أنه ظاهرة تاريخية متغيرة ومتحولة؟
المحور الأول: أشكال العنف
قبل الحديث عن أشكال العنف وأسبابه وآليات ممارسته، نرى من الضروري أولا أن نحد مفهوم العنف، يقصد بالعنف عموما خاصية ظاهرة أو فعل عنيف، فنقول زلزال عنيف أو انفجار عنيف، وفي المجال السياسي يقصد بالعنف الاستعمال اللامشروع وغير العادل للقوة حسب معجم لالاند، ومن ثم فإن العنف هو إلحاق أذى جسمي أو نفسي أو معنوي بفرد أو جماعة بشرية، وبالتالي فإن العنف تعددت أشكاله، منها: العنف المادي، العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف المعنوي، كما تنوعت أدوات وتقنيات ممارسته بدأ من الكلام إلى وسائل التعذيب الحديثة التي أنتجتها الحضارة الحديثة، ومن ثم انتقلنا من عنف الطبيعة (الزلازل، البراكين، الفيضانات...) إلى عنف الإنسان إلى درجة أصبح العنف يشكل جوهر الإنسان وماهيته، لذلك يعرف "روجيه دادون" الإنسان في كتابه "العنف" بالكائن العنيف الذي يتحدد بأنه مبني داخليا وعضويا بالعنف، لقد عرف تاريخ البشرية أشكالا متعددة للعنف، حيث بدأ بممارسة القوة العضلية إلى التفوق الرمزي والعقلي، وهذه السيرورة تعكس مدى محايثة العنف للبشر، وصعوبة التخلص منه أو تجاوزه رغم التطور الهائل الذي عرفه الإنسان في مجالات حياته، ولذلك يرى فرويد أن القوة العضلية الأكثر تفوقا هي التي كانت تقرر من يملك الأشياء وإرادة من تسود، إلا أن في اللحظة التي أدخلت فيها الأسلحة بدأ التفوق العقلي يحل محل القوة العضلية الغاشمة (فرويد، أفكار لأزمنة الحرب والموت ....).
إن العنف إذن واقعة اجتماعية وتاريخية انتشرت في المجتمعات الإنسانية الراهنة، بل أكثر من ذلك، إن تطور البشرية صاحبه تطوير تقنيات ووسائل ممارسة العنف إلى درجة دفعت ببعض الفلاسفة إلى القول إن الحرب أو العنف هو محرك التاريخ، وبالمقابل طورت البشرية عبر تاريخها آليات ووسائل للحد من انتشار ظاهرة العنف، حيث لعبت الديانات والثقافات ومؤسسات المجتمع المدني ذات النزعة الإنسانية والأخلاقية دور الكابح المعنوي والأخلاقي للقضاء على العنف أو على الأقل التقليل من انتشاره، من هنا تأتي قيمة مواقف الفلاسفة من ظاهرة العنف، نذكر على السبيل المثال لا الحصر موقف اريك ويل الذي جعل مهمة الفيلسوف تكمن في نبذ العنف والقضاء عليه أو على الأقل الحد منه لنشعر الإنسان بكرامته في حياته اليومية، من أجل بناء مجتمع مدني يقوم على الحوار والتعايش بدل الحروب والعنف، فهل وفقت الدولة الحديثة والنظام الديمقراطي في تثبيت ثقافة الحوار والتسامح والقضاء على العنف، أم أن هذا الأخير أكثر رسوخا وأعمق أثرا في المجتمعات الراهنة؟
المحور الثاني: العنف في التاريخ
إذا كانت السلطة هي الأداة الضرورية لتحقيق قيم إنسانية مثلى، سياسية كانت أم أخلاقية، مادامت هذه القيم مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة السلطة التي يتعين عليها ترجمتها على أرض الواقع، فإن مقاربة مفهوم السلطة انطلاقا من التاريخ البشري تصطدم بظاهرة العنف الذي يعد من مكونات السلطة وركائزها الأساسية، وهو في نفس الآن يهدد وجودها واستمراريتها، وعليه فإن كل القيم الأخلاقية والسياسية تظل مرتبطة بشكل أو بآخر بظاهرة العنف.
لم يحضر مفهوم العنف في الفلسفة اليونانية كإشكالية فلسفية متميزة وواضحة المعالم، بحيث لا نصادف في حوارات أفلاطون، ولا في الكتب السياسية أو الأخلاقية لأرسطو قولا حول حقيقة العنف وماهيته، ومع ذلك فإن كتابات أفلاطون وأرسطو تبقى في عمقها مناهضة لكل شكل من أشكال العنف، حيث يعتبران أن السياسة الحقة هي التي تتميز بالمساواة والانسجام الفردي والجماعي وتحقق الوحدة والتضامن، وتغيب فيها كل مظاهر العنف والصراع، الشيء الذي لا يحصل في نظام الطاغية الذي يقوم على العنف والسيطرة، لأن ما يتوخاه الطاغي هو إخضاع الناس واستعبادهم بغية تحقيق مصالح فردية وخاصة.
نفس الأمر نجده لدى الفارابي حيث يشير في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" إلى أن الغلبة والقهر من خاصيات المدينة الضالة لا المدينة الفاضلة، إذ يقول في هذا السياق: "مدينة التغلب وهي التي قصد أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهم، الممتنعين أن يقهرهم غيرهم، ويكون كدهم اللذة التي تنالهم من الغلبة فقط".
يمثل العنف إذن عنصرا أساسيا في العلاقات الاجتماعية ولاسيما في المرحلة الطبيعية حيث يخضع فيها الإنسان لأهوائه وغرائزه ويمارس العنف على أخيه الإنسان من أجل البقاء والحفاظ على الذات، والحق ينال بممارسة القوة والعنف، كما يذهب إلى ذلك هوبز حيث يصف الحالة الطبيعية الأولى للإنسان بأوصاف قاتمة، منها: "حرب الكل ضد الكل"، لكن ماركس يرى أن العنف إفراز تاريخي نتج عن تعارض المصالح لما ظهرت الملكية الفردية، ومن ثم فإن العنف لا يمثل أحد المكونات الطبيعية للسلطة، بل هو ناتج عن الواقع الاجتماعي، وعليه فإن الدولة والعنف قابلان للتغير والاختفاء في ظروف تاريخية مغايرة.
نخلص إذن إلى أن العنف في نظر ماركس ضرورة تاريخية، ولكن يجب القضاء على كل مظاهره بعد المرحلة الانتقالية المتمثلة في دكتاتورية الطبقة البروليتاريا، ومن ثم يتعين تهيئ وتنظيم الثورة وتأطير العنف الجماهيري، أما ميشل فوكو فيرى أن العنف متواجد في عدة مستويات وله مظاهر مختلفة، وكثيرا ما يرتبط بالسلطة وبالسياسة والظروف التاريخية: فهناك عنف في المعرفة والخطاب، وعنف في القوانين، وعنف في المؤسسات الطبية والملاجئ، وعنف في السجون ...، على أن العنف الذي يحمل دلالة خاصة بالنسبة للمجتمع الحديث هو ذلك الذي يتجلى في مؤسسات السجون، فيتعرض الإنسان في السجن لأفظع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، إن الغاية المتوخاة من ممارسة العنف تتمثل في تطويع الأجساد وتذويب العقول وغرس الرعب في النفوس، قصد إقبار كل نزوع إلى العصيان والتمرد والقضاء بصفة نهائية على كل روح نقدية، ولما يفرج عن الإنسان يكون فاقدا لذاته ولوعيه الاجتماعي وفي اغتراب تام.
المحور الثالث: العنف والمشروعية
إن السلطة السياسية بمعناها الحديث لا تقوم على السيطرة والغلبة والعنف كما يذهب إلى ذلك كثير من المفكرين الذين يعتقدون أن من أهم القواعد السياسية التي يجب أن يتمسك بها الفاعل السياسي، وهي ضرورة اللجوء إلى العنف الذي يعد من المكونات الأساسية لكل عمل سياسي يتوخى النجاعة والفاعلية، ما دامت السياسة مجال للصراع الدائم والمستمر حول القيادة والزعامة، فالعنف إذن هو الشرط الأساسي الكفيل بتحقيق التوازن الاجتماعي، حيث يحافظ على كيان المجتمع، بل ينقذه في الحالات المتأزمة، يمكن الحديث عن تداخل عضوي بين العنف والسياسة لكن السلطة السياسية اليوم أصبحت تتأسس على التجاور والتواصل والتداول، ومن هنا فإن العنف يتعارض جوهريا مع الممارسة السياسية، بل يقصيها ويغيبها مادام يرتبط بأفعال غير سياسية في عمقها، مثل التحايل، الضبط أو التطويع الاجتماعي والتحذير الاديولوجي، ولذلك، تقول "حنا أراندت" في كتابها "ما هي السياسة" "إن السلطة والعنف يتعارضان: فحين يحكم أحدهما حكما مطلقا يكون الآخر غائبا، ويظهر العنف لما تكون السلطة مهددة"، ومن ثم يمكن القول إن الفلسفة السياسية بمفهومها الحديث تنبذ كل أشكال العنف لأنها تهدف أساسا إلى التفكير والتأمل في القيم الإنسانية في بعدها السياسي والأخلاقي استنادا إلى الحوار والاعتراف بالغير مهما كانت خصوصيته السوسيو ثقافية (اللغة، الدين، العادات والتقاليد...)، فالفلسفة وجدت من أجل مواجهة ومحاربة العنف، ولذلك تواجه العنف غير المشروع بالعنف المشروع، أي بالخطاب المعقول والمتماسك، أو كما يسميه "إريل فايل" باللاعنف الذي هو نقطة البداية والهدف المنشود لكل ممارسة فلسفية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق مفاده: هل نجحت الفلسفة في هذه المهمة، أي القضاء على العنف؟ أو على الأقل الحد من انتشاره؟
في الواقع إنه إذا تم الاتفاق أن هناك تقهقرا أو تراجعا للعنف السياسي والاقتصادي، فإن هناك أشكال أخرى من العنف بدأت تتقوى ويتسع مجالها في الحياة الإنسانية، مثل عنف الملاعب الرياضية، والمدارس، وعنف الجماعات المتطرفة، وعنف الأسرة إلخ ...، لذلك فإن المهمة الأساسية للفلسفة ورهانها الأساسي هو احتواء كل مظاهر العنف ومحاربتها بوصفها تهديدا للعقل، وضد الخطاب المتماسك والنقدي، ومن ثم ضد الترابط الاجتماعي وقيم الحداثة، لأن مثل هذه الممارسات التي تتأسس على العنف هي تهديد للإنسان، ومع ذلك فإن اللجوء إلى العنف يمكن تبريره واعتباره ممارسة عقلانية ومنطقية في بعض الحالات، مثل: الدفاع عن النفس، مقاومة الاضطهاد ومحاربة العنصرية، كما تذهب إلى ذلك "حنا أراندت".
ومهما يكن من أمر فإن العنف لا يمكن أن يكون مبررا ومشروعا، لأنه ذو طبيعة "أداتية"، فهو دائما موجه للاستعمال، ويعمل على تحطيم كل سلطة متوافق عليها، وبالتالي فهو يحطم شروط إمكان قيام جماعة.